التبويبات الأساسية
مفهوم المواطنة في الوعي السوري

اتسمت مرحلة ما بعد الاستقلال بإعلاء الحس الوطني السوري فوق الروابط ما قبل القومية، إذ رفض السوريون آنذاك أن تكون الهويات والانتماءات المحلية قاعدة للاجتماع السياسي. وبمجيء ثورة الثامن من آذار عام 1963 لم تُتح السلطات المتعاقبة الفرصة للسوريين للحديث عن هويات متعددة بوضوح وشفافية، حيث طغى خطاب قومي متعالٍ حاول ردم الأزمات أو دفْنها بدلاً من البحث في حلول لها.
لقد عُرف المجتمع السوري بتنوعه من حيث الأعراق والديانات والمذاهب،ولم يكن هذا التنوع مصدر أزمة تنذر بالانفجار لو أُتيح له المناخ الديمقراطي الملائم لبلورة المفاهيم والقناعات وتحديد الحقوق والواجبات معاً، وكذلك كان من الممكن جداً أن يكون هذا التنوع مصدر قوة وثراء لسوريا والسوريين لو كان منتظماً في عقد اجتماعي يسهم السوريون جميعاً في صياغته وتحديد ملامحه ويحظى بقبول الجميع.
لا تتجسّد أزمة المواطنة في سوريا في غيابها عن وعي السوريين،بل تتجسد في تغييبها،وفي محاولة إيجاد أشكال أخرى من الولاءات تلبي رغبة وحاجة السلطة الحاكمة أكثر مما تعبر عن نزوع وطني حقيقي لدى المواطنين. لقد فرض نظام البعث منذ مجيئه إلى السلطة فهماً قسرياً وفوقياَ لمفهوم المواطنة، ولعل هذا الإجراء القمعي لا تطال تداعياته مكوّناً محدّداً من مكوّنات الشعب السوري بقدر ما تطال المجتمع برمته، وهذا لا ينفي – بالطبع – أن بعض المكوّنات قد طالها الأذى أكثر من سواها -كما حال الإخوة الكرد - بسبب حرمان قسم كبير منهم من حق الجنسية بالإضافة إلى حقوقهم الثقافية والاجتماعية.
تجليات الأزمة
منذ عام 1970 يعتاش نظام الأسد على خطاب قومي تقليدي يخفي تحته كل سوءات الاستبداد والتسلط والفساد وحرمان السوريين من أدنى حقوقهم المشروعة، فتحت شعار (تحرير فلسطين ومقاومة الصهيونية وتحرير الجولان والعمل من أجل الوحدة العربية ) فقد تمّ فرض قانون الطوارىء واستمرار العمل بموجبه طيلة ما يقارب نصف قرن من الزمن،وكذلك تم تعطيل الدستور وتغييب الحريات وعدم السماح بتشكيل الأحزاب السياسية، وفي موازاة ذلك كان هناك تغوّل كبير لأجهزة الأمن وسعيها المستمر لمحاصرة المواطن والتضييق عليه ليس بمصادرة حقوقه السياسية فحسب،بل في أدنى حقوقه المعيشية أيضاً. وبات أي حديث أو تلميح إلى حقوق المواطن في الحرية والعيش الكريم يُعدّ مساساً بأمن الدولة وتهديداً لسلامتها،وكذلك بات أي حديث عن حقوق مكوّنات الشعب السوري الثقافية أو الاجتماعية يُعدّ ضرباً من الخيانة أو محاولة لتفتيت الدولة. كما بات يُنظرإلى أي نقد أو ملاحظة يبديها المواطن تجاه رجل السلطة تُعدّ على أنها مساس بهيبة الدولة قد يدفع المواطن حياته ثمناً لها، مما أدّى إلى اختزال القيم الوطنية في شخص الحاكم الذي يتمتع بالمنعة والعصمة من أي نقد أو ملاحظة. وكان من نتيجة ذلك أن قوّة الدولة وهيبتها أصبحت تتجسدّ بقوة رجال الأمن وخفر السلطة ، الأمر الذي يؤكد أن شرعية لقد جاءت الثورة السورية في ربيع عام 2011 لتزيل الركام عن عمق الإشكاليات والتناقضات المركونة والمسكوت عنها طيلة فترة طويلة من الزمن،ولعل فداحة الأمر- فيما أعتقد- إنما تتجسد في انفجار هذه الإشكاليات المجتمعية دون ضابط قيمي أو قانوني يمكّن من السيطرة عليها، وليست مظاهر التطرف والنزوع إلى العنف المسلح وكذلك الخطاب السافر عن الطائفيةوالمذهبية، أضف إلى ذلك التراجع الجماعي إلى المكوّنات والولاءات الفرعية البدائية كالعشيرة والطائفة والمذهب،إلا نتاجاً طبيعياً لسبات اجتماعي وسياسي طويل، بل لتخلف شديد ألجأ السوريين إليه نظام شمولي مستبد.
إلا أنه من جهة أخرى، لا يمكن تبرئة النخب السياسية والثقافية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني من المسؤولية عما آلت إليه الحال، فعلى الرغم من انعدام الشروط الصحية للعمل السياسي في سوريا،وكذلك على الرغم من اغتيال السلطة للمناخ الاجتماعي الآمن الذي يتيح للأفراد الحصول على حقوقهم، فإنه من جانب آخر لا يُظهر الخطاب الثقافي والسياسي للمعارضة والنخب السورية رغبة جادة في محاصرة وتفكيك الإشكاليات الناجمة عن مرحلة الاستبداد،فحديث السوريين ونقدهم للطغيان والاستبداد لا يوازيه مشروع ثقافي واضح المعالم والأهداف والآليات لمكافحة الطغيان والاستبداد،وكذلك نقد الطائفية والمذهبية لم يتأطر ضمن مشروع سياسي أو ثقافي ممنهج يهدف إلى تشخيص الظواهرووضع آليات ووسائل لحلها.
وإني على يقين من أن الثورة السورية غنية بكشوفاتها المعرفية والثقافية أكثر بكثير من إرهاصاتها السياسية، ولكن المعضلة تكمن في عدم إدراك القيمة الحقيقية لفاعلية الثقافة ودورها في تشكيل وعي اجتماعي قادر على استيعاب وتخطي التناقضات الاجتماعية،وقادر في الوقت ذاته على إنتاج تصورات ورؤى مبدعة لسبر الواقع وتحليل ظواهره وإشكالياته.
إن استفحال العنف المسلح وشيوع التطرف والتعصب الديني والمذهبي، وكذلك الارتكاس إلى الحواضن الاجتماعية البدائية كالعشيرة والطائفة والمذهب، إنها كلها ظواهر معيقة لأي تحول اجتماعي ديمقراطي، وهي بمجملها تعبير عن غياب حقيقي لمشروع أو مشاريع ثقافية تعمل على التأسيس لوعي اجتماعي يتقوّم على قيم الحرية والكرامة والتسامح وحقوق الإنسان
ذلك أن مقاومة التطرف الديني والمذهبي والعنف المسلح والنزعات الطائفية وغياب قيم التآلف الاجتماعي لا يمكن علاجها بعنف مضاد أو بطائفية مضادة،أو بالمزيد من تشكيل الفصائل العسكرية ذات الأجندات المشبوهة، بل بالعمل الدؤوب والمنظم على استيعاب جميع الجهود الثقافية والسياسية بغية تأطيرها ببرنامج وطني واضح المعالم والأهداف يعمل من خلاله الجميع على صياغة عقد اجتماعي جديد يحظى بقبول السوريين ويلبي تطلعاتهم ويحقق مصالحهم ، ليكون أفقاً يمكّننا من العبور إلى سورية الجديدة.

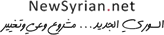









علِّق